انتقال شعلة الحضارة إلى العرب المسلمين
بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية منتصف القرن الخامس بعد الميلاد امتصت البابوية في أوروبا تدريجيا سلطة الأباطرة والملوك حتى امتلكت ثلث الأرض في القرن الثالث عشر، وتولت عمليا إدارة شؤون الدول والمجتمعات في أوروبا. يطلق بعض المؤرخين اسم العصور المظلمة على الفترة التي تلت سقوط الإمبراطورية الرومانية والممتدة بين القرنين الخامس والخامس عشر للميلاد، أي حوالي 1000 سنة، ساد فيها الجهل والتخلف و طوقت الكنيسة العقل الأوروبي اليافع بعقيدة محدودة، أما ما ظهر من بعض الأفكار العلمية في عصور الظلام تلك في أوروبا، فقد قُمعت في مهدها من قبل السلطات الكنسية الحاكمة، فأحيل العالم والفلكي (غاليلي) الذي قال بدوران الأرض مثلا إلى ديوان التفتيش في روما بعد أن أضحى شيخاً متوعك الصحة، وهناك تحت التهديد والتعذيب أجبر على التصريح بأن أفكاره كانت خاطئة، وأنه قد تنازل عنها، ثم عُزل في منزل قريب من (فلورنسا)، وكان ممنوعا عليه دخولها، ومنعت قراءة كتبه.
كما أُحرِق المفكر (جيوردانو برونو) حيا
بعد أن أُغلِق فمه بمسمار لأنه كان يؤمن بأن الأرض ليست الكوكب الوحيد الذي تقوم عليه
الحياة بل يمكن أن تكون هناك كواكب أخرى شبيهة بالأرض[1].
يقول برونو في كتابه: "عوالم متعددة
وكون بلا نهاية":
"في الكون شموس لا تكاد تحصى، وكواكب
تدور حول شموسها تماماً كما تدور الكواكب حول الشمس، إنـا نرى الشموس لأنها مضيئة ولأنها
أكبر حجماً، أما الكواكب التي تتبعها فتبقى غير مرئية لأنها أصغر من شموسها بكثير ولأنها
لا تشع الضوء بذاتها". وقد اعتبرت الكنيسة أفكار برونو هذه كفرا وهرطقة تتناقض
مع ما جاء في الإنجيل من أن الله قد خلق أرضا واحدة فقط، فوقع برونو ضحية أفكاره ليكون
أول شاهد على تعدد العوالم.
في هذه الفترة بالذات، كانت الحضارة الإسلامية،
قد أينعت، وبدأت تُؤتي أكلها، وكانت حواضر العالم الإسلامي منارات علم ونور للعالم
أجمع، وسيسجل التاريخ بعد بضعة قرون أن المسلمين قد حفظوا كنوز الحضارات الإنسانية
السابقة من الضياع في فترة الظلام الذي عاشته أوروبا خلال تلك العصور، لتستيقظ أوروبا
بعد ذلك أثناء ما يسمى عصر النهضة، وتضع يدها على هذا التراث التليد فيصبح البذرة الأولى
من بذور نهضتها الحديثة.
يقول (ول ديورانت) في كتابه "قصة الحضارة":
"وبلغ الإسلام في ذلك الوقت أوج حياته
الثقافية، وكنت تجد في ألف مسجد منتشرة من قرطبة إلى سمرقند، علماء لا يحصيهم العدّ،
كانت تدوي أركانها بفصاحتهم، وكانت قصور مئة أمير تتجاوب أصداؤها بالشعر والمناقشات
الفلسفية. ولم يكن هناك من رجل يجرؤ أن يكون مليونيراً من غير أن يعاضد الأدب والفن". ولقد استطاع العرب أن يستوعبوا ما كان عند الأمم
المغزوة من ثقافات بما اتصفوا به من سرعة الخاطر وقوة البديهة، حتى لقد أظهر الفاتحون
كثيراً من التسامح مع الشعراء والعلماء والفلاسفة الذين جعلوا من اللغة العربية أوسع
اللغات علماً وأدباً في العالم، بحيث ظهر العرب الأصليون وكأنهم قلة بالنسبة إلى المجتمع
الجديد".
ويقول (جورج سارتون) في كتابه (المدخل إلى
تاريخ العلوم):
"كُتبت أعظم المؤلفات قيمة وأكثرها
أصالة وأغزرها مادة باللغة العربية خلال العصور الوسطى، وكانت اللغة العربية منذ منتصف
القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد لغة العلم الارتقائية للجنس البشري،
حتى أنه كان يتوجب على من أراد أن يلم بثقافة عصره بأحدث صورها، أن يلم باللغة العربية."
إذا كانت كلمة فلسفة (Philosophy) باللغة اليونانية تعني
"محبة الحكمة" فإن مرادفها نجده في الأدبيات الإسلامية الأساسية (القرآن
والسنة) وهو كلمة (حكمة) التي شاع استخدامها بين المفكرين المسلمين، وبالرغم من أن
محبة الحكمة الإسلامية قد نهلت من معين الفلسفة الإغريقية إلا أنها امتازت عنها بإبداع
توازن رائع كمنهج لتصور كامل عن العالم بأجزائه الطبيعية والإنسانية والغائية أو ما
وراء الكون، فإذا أردنا وصف الفلاسفة المسلمين بإيجاز لصح فيهم القول أنهم: "عملوا
لدنياهم كأنهم يعيشون أبدا ولآخرتهم كأنهم سيموتون غدا"، فلم يركنوا إلى قصور
العاج الوردية مبتعدين عن الحياة العامة وعن العلوم الطبيعية والبحث والتجريب، بعكس
فلاسفة الإغريق الذين احتقروا الأعمال اليدوية والتجارب الطبيعية واعتبروها أعمالا
تخص العبيد، وهم إن مارسوا هذه الأعمال يوما عللوا ممارستهم بأنها مجرد ترفيه عن عقلهم
المثقل بهموم الحكمة والمعرفة، بل ربما شعروا بالذنب لذلك.
بالمقابل نجد أن أصحاب الحكمة من المسلمين
كانوا أطباء وكيميائيين وسياسيين ... وعموما سنجدهم مبدعين في علوم الدنيا والآخرة
وفي كل ما يمت إلى صلاح أمر الإنسان بصلة.
وإذا عرّفنا الفلسفة بأنها محاولة بناء
تصور ورؤية شمولية للكون والحياة، فإن الفلسفة بدأت في الحضارة الإسلامية كتيار فكري
منذ نشأة الدولة الإسلامية تحت عنوان (علم الكلام)، ووصلت الذروة في القرن التاسع عندما
أصبح المسلمون على إطلاع بالفلسفة اليونانية القديمة مما أدى إلى نشوء رعيل من الفلاسفة
المسلمين الذين كانوا يختلفون عن علماء الكلام.
لقد استند علم الكلام أساسا إلى النصوص
الشرعية من قرآن وسنة وأساليب منطقية لغوية لمواجهة من يحاول الطعن في حقائق الإسلام،
وتبنى الفلاسفة المسلمين الذين كانت الفلسفة اليونانية مرجعهم، التصور الأرسطي (نسبة
إلى أرسطو) أو الأفلاطوني (نسبة إلى أفلاطون) الذي اعتبروه متوافقا مع نصوص وروح الإسلام.
ومن خلال محاولتهم استخدام المنطق لتحليل ما اعتبروه قوانين كونية ثابتة ناشئة من إرادة
الله، قاموا بداية بأول محاولات توفيقية لردم بعض الهوة التي كانت موجودة أساسا في
التصور لطبيعة الخالق بين المفهوم الإسلامي، الذي يقوم على وحدانية الله ويعدد صفاته
وافعاله دون أن يقارب وصفه بذاته، فالله ليس كمثله شيء، وبين المفهوم الفلسفي اليوناني
الذي يقوم على تعدد الآلهة بدلا من تعدد الصفات والأفعال، وبالنسبة لأرسطو (أبو الفلسفة
اليونانية)، فقد تحدث عن المبدأ الأول أو العقل الأول الذي خلق العالم ووصفه بالجلال
والكمال بينما اعتبر العالم والله موجودين منذ الأزل وبذلك جرد الله من صفة إرادة الخلق
متى وكيف يشاء.
تطورت الفلسفة الإسلامية من مرحلة دراسة
المسائل التي لا تثبت إلا بالنقل والتعبّد إلى مرحلة دراسة المسائل التي ينحصر إثباتها
بالأدلة العقلية ولكن النقطة المشتركة عبر هذا الامتداد التاريخي كان معرفة الله وإثبات
وجود الخالق.
بلغ هذا التيار الفلسفي منعطفا بالغ الأهمية
على يد ابن رشد من خلال تمسكه بمبدأ الفكر الحر وتحكيم العقل على أساس المشاهدة والتجربة.
برز من فلاسفة المسلمين الكندي الذي يلقب
بالمعلم الأول، ثم الفارابي الذي تبنى الكثير من الفكر الأرسطي. أسس الفارابي مدرسة
فكرية كان من أهم أعلامها: الأميري والسجستاني والتوحيدي.
أما الغزّالي فكان أول من أقام صلحا بين
المنطق والعلوم الإسلامية استخدمه في علم أصول الفقه، لكنه بالمقابل شن هجوما عنيفا
على الفلاسفة في كتابه "تهافت الفلاسفة"، الذي رد عليه بعد بضعة عقود ابن
رشد في كتابه "تهافت التهافت".
في إطار هذا المشهد كان هناك دوما اتجاه
قوي يرفض الخوض في مسائل البحث في الإلهيات وطبيعة الخالق والمخلوق ويفضل الاكتفاء
بما هو وارد في نصوص الكتاب والسنة، هذا التيار الذي يعرف أصحابه "بأهل الحديث"
والذي ينسب له معظم من عمل بالفقه الإسلامي والاجتهاد، كان دوما يشكك في جدوى الحجج
الكلامية والمنطق.
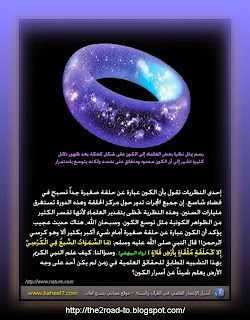

تعليقات
إرسال تعليق