شمس الله تسطع على الغرب
شمس الله تسطع على الغرب[1]
إن دراسة السيرة الذاتية وإبداع فلاسفة ومفكري
وعلماء العصر الذهبي من الحضارة الإسلامية يتطلب مجلدات من البحث والتنقيب، لكننا
سننتقي من هذا الفيض شذرات من أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية في أول
نهضتها:
للتفكير العلمي خصائص لا يستقيم دونها، من ذلك أن
يبدأ العالم بحثه دون تحيز لأية معلومات سابقة، إنّ مشكلة المنطق الأولى هي تتبع
مصادر أخطاء العقل والتصدي لها، هذه الأخطاء يمكن أن تنجم عن التسليم بآراء
الآخرين أو عن غموض اللغة كأداة للتفاهم والتعبير عن الأفكار أو الأخطاء التي تغري
بها الطبيعة البشريّة، كالميل إلى التسرع في إصدار الأحكام والانسياق مع الأهواء
والمصالح التي تقود إليها الميول الفردية من سماحة أو تعصب أو تفاؤل أو تشاؤم، أما
مفتاح البحث فهو التجربة، وهي تدبير لظروف ملائمة للإجابة على تساؤل محدد، أو بمعنى
آخر فالتجربة هي توجيه سؤال إلى الطبيعة حول فكرة تتطلب الجواب، وعلى الباحث أن
يتخلى عن الفكرة التي جعلها أداة لتفسير الطبيعة متى أثبتت التجربة بطلانها.
لقد نزع العلم الحديث إلى الرصد وتحويل الكيفية
إلى كمية والتعبير عن وقائع الحس بالرسوم البيانية والجداول الإحصائية، مستعيناً
بالتقدم الهائل الذي أحرزته آلات الرصد، كالآلات الحاسبة، وأجهزة التقريب الضوئية
والراديوية التي تُستعمل في علم الفلك، وأصبح مردّ الدقة في القوانين العلمية يعود
إلى صياغتها الرياضيّة، فأين وقفت المدنية العربية الإسلامية من منهج البحث العلمي،
وكيف تأثر الباحثون الغربيون بذلك؟
لقد أوجب العلماء المسلمون على الباحث أن يطهر
عقله من كل ما يحتويه من أفكار مسبقة حول موضوع البحث متوسلين إلى ذلك بالشك، يقول
إبراهيم النظام (و840 م): "لم يكن يقين قط حتى صار فيه شك، ولم ينتقل أحد من
اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شك". ويقول الجاحظ (و869 م): "
تعلم الشك في المشكوك فيه تعلماً، فلولم يكن ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت، لأوفى
بما يحتاج إليه، والعوام أقل شكوكاً من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق ولا
يرتابون بأنفسهم، فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد، أو التكذيب المجرد."
كذلك فإن الغزالي (و1111م) زاول الشك قبل التيقن،
قال في (المنقذ من الضلال): "لو لم يكن في هذه الألفاظ إلا ما يشكك في
اعتقادك الموروث لكفى بذلك نفعاً فإن من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن
لم يبصر بقي في العمى والحيرة."
وقد نبه الحسن بن الهيثم(و354هـ/965م) في كتابه
(مقدمة الشكوك على بطليموس) إلى "أنّ حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في
طباع البشر، وأنّه كثيراً ما يقود الباحث إلى الضلال ويعيق قدرته على كشف
مغالطاتهم، وانطلاقه إلى معرفة الجديد من الحقائق، وما عصم الله العلماء من الزلل،
ولا حمى علمهم من التقصير والخلل ولو كان ذلك كذلك، لما اختلف العلماء في شيء من
العلوم، ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور".
لقد فطن رواد الحضارة الإسلامية إلى التجربة
كأداة فعالة في مسالك البحث العلمي، من ذلك أن جابر بن حيان (توفي 198هـ/813 م)
سماها بالتدريب. يقول في كتاب (السبعين):" فمن كان دَرِباً (مجرّباً)، كان
عالماً حقاً، ومن لم يكن درباً لم يكن عالماً، وحسبك بالدربة (إجراء التجارب) في
جميع الصنائع، أن الصانع الدرب يحذق، وغير الدرب يُعطِّل."
كما كان البيروني (ولد 362هـ/973 م) من أئمة رواد
البحث التجريبي، وقد استطاع من خلال تجاربه تحديد الثقل النوعي لكثير من المواد
بدقة تثير الإعجاب، كذلك فقد نزع العلماء المسلمون إلى تكميم النتائج توخياً
للدقة، من ذلك أنّ جابر بن حيان جعل الميزان أساس البحث التجريبي، وقد عرّف مفهوم
الكمية بقوله: "إنها الدالة المشتملة على قولنا الأعداد، مثل عددٍ مساو لعدد،
وسائر الأرطال والأعداد والأقدار من الأوزان والمكاييل وما شابه ذلك."
وقد صنع المسلمون آلاتٍ دقيقة استخدموها في
بحوثهم التجريبية، لعلّ أهمها تلك التي استخدمت في علوم الفلك والجغرافيا
والطبيعة، كالحلقة الاعتدالية، وهي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل ليعلم بها
التحول الاعتدالي للأرض، وذات الأوتار، وهي أربع اسطوانات تغني عن الحلقة
الاعتدالية على أنها يعلم بها تحول الليل أيضاً، وذات السمت والارتفاع ويعلم بها
السمت والارتفاع، والمشبهة بالناطق، وهي ثلاث مساطر، اثنتان منظمتان ذات شعبتين،
ويقاس بها البعد بين كوكبين، والمزاولة (الساعة الشمسية)، والإسطرلاب وهو جهاز
يستطيع الفلكي أن يعين به زوايا ارتفاع الأجرام السماوية عن الأفق في أي مكان. وقد
استخدم البيروني جهازاً مخروطياً لتحديد الثقل النوعي يعد اليوم من أقدم أجهزة
القياس.
لقد وضع علماء المسلمين دراسة مفصلة عن الكواكب
وأحجامها، وعرفوا كثيراً عن الأرض وكرويتها وحركتها حول الشمس. يقول الشريف
الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق):" إنّ الأرض مدوّرة كتدوير الكرة".
وقد كلف الخليفة العباسي (المأمون)، موسى بن شاكر
الذي برز هو وأولاده الثلاثة محمد وأحمد وحسن في الرياضيات والميكانيكا (علم الحيل
كما أسموه)، بقياس محيط الأرض، وبعد الحساب الطويل والدقيق، توصلت البعثة التي
قامت بالقياس إلى أن المحيط يساوي 47356 كيلومتر، وهذه النتيجة قريبة من الحقيقة
إذ أن القياس الأخير لهذا المحيط يساوي 40000 كيلومتر تقريباً. ويعزى لبني موسى بن
شاكر القول بالجاذبية بين الأجرام السماوية التي قال بها (إسحاق نيوتن) بعدهم
بمئات السنين.
كذلك فسر علماء العرب والمسلمين بكثير من الدقة
الظواهر الكونية التي تبدو في أوقات الشفق أو كسوف الشمس، وقوانين علم النبات
وغيرها كثير.
لقد امتاز العلماء المسلمون بالموسوعية والإحاطة
بكثير من فروع المعرفة، فلم يكن الرازي مثلا طبيبًا وحسب، ولا معلمًا وحكيما فقط
... ولكنه أبدع كذلك في مجالات الأخلاق والقيم والدين، حتى أصبح علمًا من أعلام
الفضيلة إضافة إلى كونه علمًا من أعلام الطب، فكان بحق نموذجا من أفضل نماذج
الحضارة الإسلامية.
اهتمَّ الرازي أيضًا بالعلوم التي لها علاقة
بالطب، كعلم الكيمياء والأعشاب، وكذلك علم الفلسفة؛ لكونه يحوي آراء الكثير من
الفلاسفة اليونان والذين كانوا يتكلمون في الطب أيضًا، ونجد أن الرازي كثيرًا ما
انتقد آراء العلماء السابقين نتيجة تجاربه المتكررة، بل إنه ألَّف كتابًا خصِّيصًا
للرد على جالينوس أعظم أطباء اليونان وسمَّى الكتاب "الشكوك على
جالينوس"، وذكر في هذا الكتاب الأخطاء التي وقع فيها جالينوس، والتصويب الذي
قام هوبه لهذه الأخطاء، وكيف وصل إلى هذه النتائج. بل إن الرازي وصل إلى ما هو
اروع من ذلك، حيث أرسى دعائم الطب التجريبي على الحيوانات، فقد كان يجرب بعض
الأدوية على القرود فإن أثبتت كفاءة وأمانًا جربها مع الإنسان، هذا، وإن معظم
الأدوية الآن لا يمكن إجازتها إلا بتجارب على الحيوانات كما كان يفعل الرازي.
ولقد كان من نتيجة هذا الأسلوب العلمي المتميز
للرازي، أن وصل إلى الكثير من النتائج المذهلة، وحقق سبقًا علميًّا في كثير من
الأمور. فالرازي هو أول مبتكر لخيوط الجراحة، وقد ابتكرها من أمعاء القطط، وظلت
تستعمل بعد وفاته لعدة قرون، ولم يتوقف الجراحون عن استعمالها إلا منذ سنوات
معدودة في أواخر القرن العشرين، عندما اخترعت أنواع أفضل من الخيوط، والرازي هو
أول من صنع مراهم الزئبق، وهو أول من فرَّق بين النزيف الوريدي والنزيف الشرياني،
واستخدم الضغط بالأصابع لإيقاف النزف الوريدي، واستخدم الربط لإيقاف النزيف
الشرياني، وهذا بالضبط ما يستخدم الآن، وهو أول من وصف عملية استخراج الماء من
العيون ... وهو أول من أدخل المليِّنات في علم الصيدلة ... وهو أول من اعتبر
الحمَّى عرضًا لا مرضًا، وكان يهتم بالتعليق على وصف البول ودم المريض للخروج
منهما بمعلومات يستفيد منها في العلاج، كما نصح بتجنب الأدوية الكيميائية إذا كانت
هناك فرصة للعلاج بالغذاء والأعشاب، وهو عين ما ينصح به الأطباء الآن.
ولم يكن الرازي مبدعًا في فرع واحد من فروع الطب،
بل قدم شرحًا مفصلاً للأمراض الباطنية والأطفال والنساء والولادة والأمراض
التناسلية والعيون والجراحة وغير ذلك مما يساعد على شفاء الأمراض.
من أعظم مؤلفات الرازي كتابه "الحاوي في علم
التداوي"، وهو موسوعة طبية شاملة لكافة المعلومات الطبية المعروفة حتى عصر
الرازي ... وقد تُرجِم هذا الكتاب إلى أكثر من لغة أوروبية، وطُبع لأول مرة في
(بريشيا) في شمال إيطاليا سنة 891هـ/ 1486م، وهو أضخم كتاب طُبع بعد اختراع
المطبعة مباشرة، وكان مطبوعًا في 25 مجلدًا، وقد أُعيدت طباعته مرارًا في البندقية
بإيطاليا في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)، ويذكر المؤرخ "ماكس
مايرهوف" أنه في عام 1500 ميلادية كان هناك خمس طبعات لكتاب الحاوي، مع عشرات
الطبعات لأجزاء منه.
لقد اعترف القاصي والداني لأبي بكر الرازي بالفضل
والمجد والعظمة والعلم والسبق، ولا نقصد بذلك المسلمين فقط، بل اهتم غير المسلمين
أيضًا بإنجازات الرازي وابتكاراته، فنجد - فضلاً عن ترجمة كتبه إلى اللغات
الأوربية وطبعها أكثر من مرة - إشارات لطيفة وأحداثًا عظيمة تشير إلى أهمية ذلك
العالم الجليل، ومن ذلك أن الملك الفرنسي الشهير لويس الحادي عشر، الذي حكم من عام
1461م إلى 1483م، قد دفع الذهب الغزير لينسخ له أطباؤه نسخة خاصة من كتاب
"الحاوي"؛ كي يكون مرجعًا لهم إذا أصابه مرض ما، ونجد أن الشاعر
الإنجليزي القديم (جوفري تشوسر) قد ذكر الرازي بالمدح في إحدى قصائده المشهورة في
كتابه (أقاصيص كونتربري) ولعله من أوجه الفخار أيضًا أنه رغم تطور العلم وتعدد
الفنون إلا أن جامعة برينستون الأمريكية ما زالت تطلق اسم الرازي على جناح من أكبر
أجنحتها، كما تضع كلية الطب بجامعة باريس نصبًا تذكاريًّا للرازي، إضافةً إلى
صورته في شارع سان جرمان بباريس.
وأبو بكر الرازي عالم موسوعي، وفيلسوف حقيقي،
أخطأ الكثيرون باتهامه في إيمانه، ولعل هذا الاتهام يرجع إلى دور الرازي الذي أسهم
في تأسيس علم مقارنة الأديان أو الملل والنحل، والذي لم يعن فيه بالنفي أو الإثبات
وإنما التزم بحدود الوصف والتفسير فحسب، كما يرجع في شيء منه إلى موقفه العقلي
المتفرد، ويمكننا اعتبار الرازي ممثلا للنـزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية،
وهو على خلاف الكثيرين من دعاة المنهج العقلي لا نجد عنده انفصالا بين المنهج
والموضوع، أو ازدواجية في الفكر، ولكننا نلمس في أعماله بالفعل الوحدة الحقيقية
بين منهج المعرفة وموضوعها وبين النظر والعمل، ولا نعدو الصواب إن قلنا إنه تجسيد
لمفهوم الحكيم، وكان ممثلا للاتجاه المنهجي المقنن في الدراسات الأخلاقية، ولذا
يمكن اعتباره مصلحا اجتماعيا إلى جانب كونه عالما وفيلسوفا، كما نلاحظ من خلال
نصوص الرازي وفلسفته أنه يستخدم الشك المنهجي وقد سبق بذلك كلا من الغزالي وديكارت.
يلخص الرازي فلسفته بإيجاز وبأروع الكلمات كما
يلي:
"إن أفضل ما خُلقنا من أجله وإليه يجب أن نسعى هو تحصيل العلم وتطبيق
العدل اللذين بهما يكون خلاصنا من عالمنا هذا إلى العالم الذي لا موت فيه ولا ألم
... إنه لما كان البارئ عز وجل هو العالم
الذي لا يجهل والعادل الذي لا يجور، وهو العلم والعدل والرحمة بالمطلق، وهو لنا
بارئ ومالك ونحن له عبيد مملوكون، وكان أحب العبيد إلى مواليهم من أخذ بسيرتهم
ومضى على سننهم، كان أقرب عبيد الله جل وعز إليه أعلمهم وأعدلهم وأرحمهم وأرأفهم،
وهذا ما تعنيه الفلسفة من التشبه بالله عز وجل قدر المستطاع".
لقد كان الرازي بحق صورة رائعة من صور الحضارة
الإسلامية، قلَّما تتكرر في التاريخ، لقد كان طبيبًا وعالمًا ومعلمًا وإنسانًا..
عاش حياته لخدمة الإسلام والعلم والبشرية، ومات عن عمر بلغ ستين عامًا في شعبان
311هـ / نوفمبر (ت2) 923م.
أما الفارابي فيُعتبر فيلسوفاَ ومن أهم الشخصيات
الإسلامية التي أتقنت العلوم بصورة كبيرة كالطب والفيزياء والفلسفة والموسيقى
وغيرها.
درس الفارابي العديد من المذاهب الفلسفية لكن
أكثر ما تأثر به هو فلسفة أرسطو. اتسم الفارابي بغزارة كتاباته، ونُسب إليه أكثر
من مئة كتاب. تنوعت بين كتابات تمهيدية عن الفلسفة بصفة عامة وتعليقاته على أعمال
أرسطو بالإضافة إلى أعماله الخاصة وكانت كتاباته مُتسقة موصوفة بالترابط والمنطقية
على الرغم أنها مكونة من عدة مدارس ومذاهب فلسفية، وكذلك تأثر الفارابي بنموذج
الكواكب والشمس الذي وضعه بطليموس، كما اهتم بموقف الفلسفة الأفلاطونية مما وراء
الطبيعة ومن فلسفتها العملية والسياسية التي نجدها في (جمهورية أفلاطون).
لعب الفارابي دورًا حيويًا في انتقال أفكار أرسطو
من اليونان القديمة إلى الغرب المسيحي في العصور الوسطى وقد تأثر موسى بن ميمون
ويعد من أهم مفكري اليهود في العصور الوسطى بالفارابي لدرجة عظيمة، فمن بين
كتاباته الشهيرة مقالة هي "مقالة في فن المنطق" وفيها أوجز موسى بأسلوب
بارع أصول منطق أرسطو في ضوء تعليقات ابن سينا والفارابي. وأكّد الكاتب (ريمي
براغ) حقيقة أن الفارابي هو المفكر الوحيد الذي تعني به تلك المقالة.
ويعد كلًا من الفارابي وابن سينا وابن رشد من
أتباع المدرسة المشائية أو الاستدلالية[2]،
إلا أن الفارابي في كتابه "الجمع بين رأيي الحكيمين" حاول أن يجمع بين
كل من المذهب الأرسطي والأفلاطوني.
[1] . هذا العنوان مقتبس من
عنوان كتاب للدارسة الألمانية زيغريد هونكه، وهو باللغة الألمانية: “Allahs
Sonne über dem Abendland: unser arabisches Erbe". بمعنى شمس الله تسطع على الغرب – ما الذي ورثناه من العرب.
[2]. هي
مدرسة فلسفية في اليونان القديمة. استمدت أفكارها من الفيلسوف أرسطو الذي سمي أيضا
بالمشاء لتجواله ناشرا فلسفته. المدرسة المشائية تتخذ المنهج العقلي والاستدلال
على أسس منطقية أساسا لفكرها. ويكيبيديا.
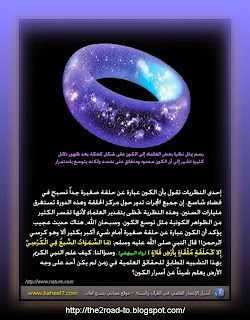

تعليقات
إرسال تعليق