أفول الحضارة العربية الإسلامية
تبدأ قصة اعتقال العقل العربي المسلم بملحمة التفكير والتكفير التي جرت بين اثنين من قامات الفلاسفة المسلمين، هما الغزّالي وابن رشد، قامتان لم يجمعهما الزمان ولا المكان، بل حب الحقيقة:
تناول الغزّالي الفلاسفة بالتحليل التفصيلي، وذكر
أصنافهم وأقسامهم، وما يستحقونه من التكفير بحسب رأيه، مما هو ليس من الدين،
واعترف في الوقت نفسه بما جاؤوا به من علوم تجريبية ناجحة، بذلك اعتُبر الغزّالي
أول عالم ديني يقوم بهذا التحليل المنهجي للفلسفة، إذ قسّم الغزّالي علوم فلاسفة
اليونان إلى العلوم الرياضية، والمنطقيات، والطبيعيات، والإلهيات، والسياسة،
والأخلاقيات، وكان جلّ انتقاد الغزّالي وهجومه على ما يتعلق بالإلهيات من الفلسفة،
إذ كان يرى فيها أكثر أخطاء الفلاسفة، وقد كفّر الغزّالي فلاسفة الإسلام المتأثرين
بالفلسفة اليونانية، وألّف كتاباً مخصوصاً للرد عليهم سمّاه "تهافت
الفلاسفة"، وفيه هاجم الفلاسفة بشكل عام والفلاسفة المسلمين بشكل خاص، وخاصة
ابن سينا والفارابي الذين هاجمهما هجوماً شديداً، فمهّد دون أن يعلم للقضاء على
الفلسفة العقلانية في العالم الإسلامي منذ ذلك الحين ولعدة قرون متواصلة. ربما كان
الغزّالي معذورا في موقفه هذا ، فقد وُجد في عصر كانت الفلسفة فيه قد أثرت في
تفكير الكثيرين من مثقفي العصر وسلوكهم، وأدى فهمهم السطحي للفلسفة إلى التشكيك في
الدين الإسلامي والانحلال في الأخلاق، والاضطراب في السياسة، والفساد في المجتمع،
فتصدّى لهم بعد أن عكف على دراسة الفلسفة لأكثر من سنتين، حتى استوعبها وفهمها،
وأصبح كواحد من كبار رجالها، يقول عن نفسه: "ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم
الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم، من لا يقف على
منتهى ذلك العلم، حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم ... فشمرت عن ساق الجد في
تحصيل ذلك العلم من الكتب ... ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً من
سنة أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره، حتى اطَّلعت على ما فيه من خداع، وتلبيس
وتحقيق وتخيّل، اطلاعاً لم أشك فيه".
يرى الكاتب والمفكر عباس محمود العقاد، أن
الغزّالي يُعدّ في كثير من نظرياته النفسيّة والتربوية والاجتماعية صاحب فلسفة
متميّزة، وهو في بعض كتبه أقرب إلى تمثيل فلسفة إسلامية، وأنه فيلسوف بالرغم من
عدم كونه يريد ذلك، وهذا ما صرّح به كثيرون من العرب والغربيين، حتى قال الفيلسوف
المشهور رينان: "لم تنتج الفلسفة العربية فكراً مبتكراً كالغزّالي"، وقد
رأى كثير من علماء المسلمين قديماً أن الغزّالي رغم حربه المعلنة على الفلسفة، لم
يزل متأثراً بها، حتى قال تلميذه أبوبكر بن العربي: "شيخُنا أبو حامد: بَلَعَ
الفلاسفةَ، وأراد أن يتقياهم فما استطاع".
لكن، وبالنتيجة فقد فاز فكر الغزّالي المسيّج
بالأصول على فكر ابن رشد المسيّج بالعقل، وأضحى العالم العربي والإسلامي يسير منذ
قرون على نهج الغزّالي بينما سار الغرب على نهج ابن رشد وطوره وتطور معه، لقد
اختفت مؤلفات ابن رشد من المكتبة العربية والإسلامية، فهي لا تدرّس حتى للطلبة
الذين وصلوا إلى المستويات العليا في كليات الفلسفة، يعود ذلك بشكل أساسي إلى تبني
نهج في أصول المعرفة يهمل الموقف النقدي العقلاني الذي يعتمد الشك في النص، والذي
يؤرخ للفكر خارج الإطار الفكري الجامد المتحجر.
إن الأساس الذي أرساه الغزّالي في كتابه
"فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" ما زال يسيطر على أسلوب التفكير
العربي، فقد أرسى الغزّالي دون أن يشعر مبدأ التكفير الذي التقطته الجهات
التكفيرية لتقول: هذا مسلم حقيقي نعترف بإسلامه وهذا غير مسلم خرج عن الدين الحق؛
يُستتاب، فإن لم يتب توبة نرضاها (هم وليس الله تعالى) يُقْتَلْ ... إنه نوع من
ممارسة التكفير الكهنوتي الذي مارسته الكنيسة في القرون الوسطى.
إن ردَّ ابن رشد على هذا المبدأ التكفيري بعد
ثمانين عاما من إشهار الغزّالي لآرائه في كتابه المشهور "فصل المقال فيما بين
الحكمة والشريعة من اتصال"، هو ردٌ ينم عن تفكير مختلف، لأنه يعلن للقارئ أن
المؤلف سينظر بنقد صارم إلى الجهتين: الحكمة (أي الفلسفة بمفرداتنا المعاصرة) من
جهة، والشريعة من جهة أخرى، ليقارب النقائض بينهما مقاربة نقدية منصفة، دون أن
يقول هذا حق يجب أن نتقيد به ونتبعه وهذا باطل علينا أن نجتنبه، فالموقف الفلسفي
لا يتبني هذا النوع من فصل المقال.
وباختصار نستطيع القول أن الغزّالي يضع حدا
للتفكير ويكفِّر في النهاية من يختلف معه في الرأي، وهذا ما نرى نتائجه الآن على
أرض الواقع حيث تقوم الحركات التكفيرية بمصادرة حرية الرأي والمعتقد، لتقوم هي
بمحاسبة الناس على تصرفاتهم الشخصية قبل السياسية والاجتماعية والعامة، ولتوزع
صكوك الغفران على أصحاب الميمنة وسلاسل الجحيم على أصحاب المشأمة بتكفير أصول
تفكيرهم، إنهم يختارون لنا مقاطع من نصوص مقدسة اصفرت أوراقها بفعل مئات السنين
ليلزمونا بالاستراتيجية (السليمة) للسيطرة على العالم واقامة دولة شهواتهم من
السبي والحريم والأحلام المريضة منصبين أنفسهم أربابا من دون الله، ثم يتهمون من
يخرج عن استراتيجيتهم الخرقاء بالكفر والزندقة بل ويقيمون عليه حد الحرابة (قطع
الأيدي والأرجل من خلاف) أو القتل في بعض المساحات الجغرافية الضيقة الهاربة من
الزمن والتاريخ.
إن هذا النهج في التكفير يعني أن نقيم على العقل
مأتما وعويلا كما يعني نهاية التطور الذي يقوم على النقد العلمي البناء.
ينطلق ابن رشد، من فهمين للقرآن واحد للعامة
(الجمهور) وآخر للخاصة (العلماء) ويأخذ على الأشاعرة إنكارهم للأسباب والقوى
الطبيعية، إذ يعتقد أن قوانين الطبيعة التي تحكم العالم هي إرادة الله، ويرى ابن
رشد، استنادا إلى آيات القرآن، أن العالم جاء من مادة أولى وليس من عدم محض، ويؤكد
على قدم الزمان لا حدوثه.
منعطف آخر هام يفترق عنده ابن رشد عن الغزّالي،
فابن رشد لا يخشى ما يصفه اليوم بعض الكتاب العرب والمسلمين بالفكر الوافد وهو
الفكر الذي حاول الغزّالي إثبات فشله في كتابه تهافت الفلاسفة وكان يعني أرسطو
وغيره من الفلاسفة الإغريق الذين كانوا يمثلون في عصرهم أرقى سمات الفكر والحكمة،
ابن رشد لم يتردد طبعا في الاستفادة منهم، فربما لم يكن أحد يعرف آنذاك أرسطو أفضل
من ابن رشد، ولو سأل أحدهم ابن رشد إن كان يخشى أن يخسر هويته إذا قرأ أرسطو
(الكافر) لأخذه العجب من السؤال.
من المسائل التي كان لابن رشد الريادة فيها موقفه
من المرأة وتبوئها المناصب الهامة كالقضاء والحكم، وهو وإن كان شارحاً لأفلاطون
ومدينته الفاضلة فإنه لم يعترض على كثير من آراء أفلاطون في مسألة المرأة. يقول
ابن رشد في كتابه "جوامع سياسة أفلاطون" وهومن الكتب التي فُقد أصلها
العربي: "تختلف النساء عن الرجال في الدرجة، لا في الطبع، وهن أهل لفعل جميع
ما يفعله الرجال من حرب و فلسفة ونحوهما، ولكن على درجة تختلف عن درجتهم، ويتفوقن عليهم في بعض الأحيان، كما في
الموسيقى، وذلك مع أن كمال هذه الصناعة هو التلحين من رجل والغناء من امرأة. ويدل
مثال بعض أمصار إفريقية على استعدادهن الشديد للحرب؛ وليس من الممتنع وصولُهن إلى
الحكم في الجمهورية (أي جمهورية أفلاطون) ويضيف: "وبالمثل، فبما أن بعض
النساء ينشأن وهن على درجة من التفوق والفطنة فليس يمتنع أن يكون بينهن الفلاسفة
والحكام، لكن بما أن الناس دأبوا على الاعتقاد في أن هذا الصنف نادراً ما يوجد
بينهن، فإن بعض الشرائع لا تقبل المرأة في منصب الإمامة، أعني الإمامة العظمى (أي
الخلافة)".
أمضى ابن رشد عمره مدافعاً عن فكرة جوهرية تقول
بتوافق العقل مع النقل، ولعل كتابه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من
الاتصال" يعد من أهم المراجع الفكرية الفلسفية في التاريخ العربي، حيث سعى
ابن رشد لإثبات تنزه الشارعِ عن الجنون وبالتالي فلا مكان للأحكام اللاعقلانية في
الدين والحياة. ومن المفهوم قيام حرب شرسة عليه وعلى أفكاره وأن يعتبرها تجار
الدين خطراً يهدد مصالحهم ونفوذهم ونزعتهم للسيطرة على الدهماء تحت عباءة الدين.
لقد كان الحقد الذي تعرض له ابن رشد من قبل
معاصريه من الفقهاء كافياً لتأليب الخليفة المنصور الموحدي عليه ووضعه في الإقامة
الجبرية، ومنع كتبه من التداول. لقد تم الحكم على ابن رشد وأفكاره بالتكفير وأعدم
كلاهما أحياء، وهكذا سبق العرب أقرانهم الأوروبيين في مسألة التكفير وحرق الكتب
عندما قام الإسبان بعد سقوط الأندلس بإحراق الكتب العربية في ساحات غرناطة وقرطبة
واشبيلية وغيرها بحجة "التطهير" وتم إجبار المسلمين على تغيير ديانتهم
ومنعهم من استعمال اللغة العربية في الكتابة والقراءة والحديث.
لقد كفر ابن رشد بالفعل بتغييب العقل، كفر بالجهل
وعمى البصيرة ولم يقبل بالاستخفاف بعقول الناس.
ورغم أن نكبة ابن رشد لم تدم طويلاً حيث عفا
الخليفة المنصور عنه عام 595 هجرية (1198 ميلادية) إلا أنه توفي في العام نفسه عن
عمر يناهز خمسة وسبعين عاماً قضاها دفاعاً عن الحرية الإنسانية وعن مكانة العقل
البشري وعن مكانة الفلسفة بين العلوم ودورها في المجتمع.
كان ابن رشد بالفعل رائد العقلانية العربية بلا
منازع إلا أنه دُفن حياً ولم يُعِد إحياءه إلا الأوروبيين بعد وفاته بأكثر من
ثلاثة قرون وكانت كتبه تُدرّس في الجامعات الأوروبية في الوقت الذي كان العرب
(ومازالوا) يعيشون أحط عصورهم عبر تغييب العقل وتغليب النقل ومنع الاجتهاد.
لقد كانت أعمال رواد الحضارة الإسلامية إلهاما
ومرجعا ومهدا أمينا للنهضة الأوروبية عندما استفاقت في العصر الحديث من عصور
الظلام، ولئن كنا نعيش اليوم أصعب ظروف التحول التاريخي في المنطقة العربية، إلا
أننا أحوج ما نكون إلى إعادة إحياء فلسفة التنوير و ريادة العقل الذي تم تحييده
تماماً، إن الكثير من قوى الظلام القريبة والغريبة لا تريد لهذا العقل العربي أن
يتحرر، لأن يقظة هذا العقل تعرّي تلك القوى من جبروتها المزيف والمختبئ وراء عباءة
الدين من جهة ووراء عباءة المصالح الاستعمارية العالمية الكبرى من جهة أخرى.
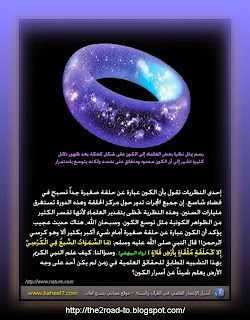

تعليقات
إرسال تعليق